أمّ رغمًا عنها
خاتمة مُترجِمة رواية “غدًا سنسافر إلى مدينة الملاهي”
“فكّرت في الأمومة، بالأساس. هذا كتاب للأمّهات. عمليًّا، للآباء أيضًا، الآباء الذين يرغبون في معرفة كيف تشعر الأمّهات” (ص 113).
أمّ فقيرة، مكتئبة، عاطلة عن العمل تسكن في بيتٍ مستأجَرٍ لا تملك النقود لسداد إيجاره، في شتاءٍ عاصفٍ وقاسٍ. أمّ شابّة تربّي، أو بالأَحرى تحاول أن تربّي طفلَيْن صغيرَيْن لوحدها في مدينةٍ قلبُها من حجر. هما طفلان وُلِدا لأمّ لا تريدهما، لا ترعاهما، لا تتواجد من أجلهما، ولكنّهما السبب الوحيد لبقائها على قيد الحياة. كيف تصبح الأمومة أمومةً؟ وما هي هذه الغريزة التي تحتّم على المرأة أن تربّي أطفالها، الغريزة التي تحتّم عليها أن تكون أمًّا، وإنْ كانت غير قادرة على ذلك؟ هل وجود الأمّ العليلة مع أبنائها هو لمصلحتهم، أم إنّه يحدّ (أو ربّما يمنع) من قدرتهم على النموّ والتطوّر والتحوّل إلى أشخاص وهُويّات في هذا العالم غير المتسامح؟ وكيف يمكن لهذه الأمّ العليلة أن تكتب روايتها في بيت ليس بيتها، وفي مساحة قد تُسلَب منها في أيّ لحظة، أو -على حدّ تعبير ﭬـيرجينيا وولف- كيف لها أن تكتب دون غرفة تخصّها وحدها؟
رواية إيلانا بيرنشطاين هي رواية تتحدّى المفهوم الـمَقوليّ للأمومة، بل هي تتحدّى كذلك المفهوم الـمَقوليّ للحضور والوجود في مفهوم الهُنا والآن. تتناول بيرنشطاين في معظم أعمالها الأدبيّة، الروائيّة والقصصيّة، ثيمةَ الأمومة والعائلة، والعلاقات الأُسَريّة والزوجيّة والوالديّة، وهي تفعل ذلك في هذه الرواية أيضًا من خلال استعراض قصّة امرأة يهوديّة إسرائيليّة تعيش في مدينة جبليّة، في ثمانينيّات القرن العشرين. تنجح بيرنشطاين في جرف القارئ إلى غياهب نفسيّة الشخصيّة الرئيسيّة في الرواية، وإلى التخبّطات والتناقضات التي تعيشها على نحوٍ متواصل ومستمرّ، وذلك من خلال أسلوب أدبيّ يبدأ في رواية القصّة بعد البداية بقليل، فلا يعرف القارئ ما الذي كان قبلها، فيجد نفسه يمسك بيد الراوية ويمشي معها، كخيالها، خطوة خطوة، ويغوص في أعماق حالتها ونفسيّتها وأفكارها ومشاعرها، حتّى يتغبّش الحدّ الفاصل بين ’الأنا’ (أي القارئ/ة) وَالـْ ’هِيَ’ (أي الراوية /الشخصيّة الرئيسيّة). للوهلة الأولى، قد يبدو للقارئ أنّ هناك شيئًا ما ليس على ما يُرام في اللغة العربيّة، أو أنّ الجُمل تبدأ من حيث يجب أن تنتهي، وتنتهي في المكان الذي كان يجب أن تبدأ به. هذا ليس خطأ أو إغفالًا، فالراوية /الكاتبة تهتمّ بأن يبقى السرد في الزمن الماضي، حتّى في الحِوارات الداخليّة بين الشخصيّات، والتي من المتّبَع أن تكون في الأدب في زمن حاضر يعبَّر عنه باستخدام الفعل المضارع، في زمن السرد. علاوة على ذلك، معظم الجُمل في الرواية هي جُمل اسميّة لا فعليّة، ويعكس هذا انعدامَ الفعل الحقيقيّ على طول الرواية؛ فالأمر الأساسيّ الذي يميّز شخصيّتها الرئيسيّة هو أنّها غير قادرة على الفعل، وأنّها تروي الرواية وكأنّها تتذكّر بنظرة إلى الوراء ومضات تعود لأشكال الأشياء وأصواتها والأحاسيس التي تُثيرها فيها، ونادرًا ما تتذكّر أفعالًا حصلت معها أو قامت بها بنفسها.

منى أبو بكر
تهتمّ الراوية /الكاتبة كذلك بأن تبقى جميع شخصيّاتها مجهولة الهُويّة، فالقارئ لا يعرف اسم أيّ من الشخصيّات، وبذا تنحصر أهمّيّة شخصيّات الرواية في تمثيلها للأدوار الاجتماعيّة التي كانت جزءًا من حياة الراوية، ممّا يعكس تأثيرها على مجرى حياتها وأحداثها اليوميّة. بالإضافة إلى ذلك، تغيب الفصول عن هذه الرواية، فيجد القارئ نفسه يواصل القراءة دون توقّف ودون أيّ أفق لـخلاص، فيقرأ ويقرأ حتّى يجد نفسه يتماثل تقريبًا مع الحالة النفسيّة للراوية، التي تصِل الليلَ بالنهار، والماضيَ بالحاضر، والحقيقيَّ بالمتخيَّل، ويتوق (القارئ) إلى الوصول إلى النهاية ليكتشف أخيرًا ما حصل /يحصل /سيحصل. “لم أفهم قَطُّ ماذا يعني عندما يقول ’تخلطين بين الماضي والحاضر’. شعرت بالخجل من السؤال. أردت أصلًا أن أعيش في المستقبل” (ص 106). هل ستكون النهاية متوقّعة حسب الأحداث المفعمة والملغومة طيلة الرواية، أَمْ ستكون مفاجِئةً وعنيفة للقارئ، لتصفعه بكلّ ما يعرفه ونشأ عليه، وتُبقيه وحيدًا يطرح على نفسه الأسئلة التي نتهرّب من طرحها على أنفسنا، وتضعه في مواجهة مع تفاهةِ ما يعتبره مفهومًا ضمنًا، وجزءًا من الـمُسَلَّمات التي نشأنا عليها؟
هذه الأدوات كلّها (البدء بعد البداية؛ غياب الضمائر؛ استخدام الفعل الماضي؛ السرد دونما توقّف؛ استخدام الجُمل الاسميّة) هي أدوات استخدمتها الكاتبة لتفكّك منظومة العلاقات البشريّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة المألوفة لدينا، فتنتقد بيرنشطاين من خلال غدًا سنسافر إلى مدينة الملاهي تَأْلِيهَ المجتمع الإسرائيليّ الصهيونيّ للأمّ، ولمؤسّسة العائلة، وللطقوس الدينيّة، وللأدوار الجندريّة.
من وجهة نظر امرأة عليلة، متعبة، مرهقة، مكتئبة، تنجح الكاتبة في نسف أحد أهمّ مقدّسات المشروع الصهيونيّ والأركان التي يقوم عليها، ولا سيّما المشروع الديمـﭽرافيّ الذي يشجّع إنجاب أطفال يهود تحت شعار “الأطفال هم السعادة”. فعلى الرغم من أنّ الشخصيّة الرئيسيّة تعبّر أكثر من مرّة أنّها تتمنّى أن “يضيع” ولداها، أو أن يأخذهما أحدٌ ما معه ويريحها من عبء الاعتناء بهما -لأنّها لا تتحمّل عبء الاعتناء بنفسها-، نجدها تقوم بكلّ ما في وسعها الضئيل من أجل أن تقوم بدور الأمّ. أحد الدوافع لذلك هو استعلاء واستهتار البيئة المحيطة بها كأمّ، على نحوِ ما نجد في توجُّه أو موقف كلّ من الجارة والمربّية والعاملة الاجتماعيّة وسكّان الحيّ منها. فبالنسبة للمجتمع الإسرائيليّ، في تلك الفترة على الأقلّ، لا تكون الأمّ أمًّا إلّا عندما يكون هناك أب إلى جانبها، وما دام الأب لا وجود له، فلا يمكن اعتبار الأمّ أمًّا، ولا تكون العائلة عائلةً: “أنا لا أُعَدّ عائلة. اخترعوا اسمًا جديدًا لمن هنّ كمثلي من النساء: أحاديّات الوالديّة. عارضتُ هذه التسمية بالطبع. لم يُسمح للولدين بالتفوّه بهاتين الكلمتين” (ص 115).بالإضافة إلى ذلك، تنتقد الكاتبة ادّعاء إسرائيل أنّها “دولة رفاهيَة”، على نحوِ ما كان الإسرائيليّون يحبّون أن يعرّفوا دولتهم آنذاك. في الوقت ذاته، عصفت بإسرائيل في الثمانينيّات أزمة تضخّم ماليّ هائل، ممّا زاد من اعتماد المواطنين على مؤسّسات الدولة والخدمات الاجتماعيّة والمعونات التي توفّرها. ولكن، على الرغم من ذلك، تشعر الشخصيّة الرئيسيّة، الأمّ، بنقمة على “المؤسّسات”، سواء أكانت المدارسَ أو صناديقَ المرضى أو قسمَ الرفاه الاجتماعيّ، أو حتّى “مؤسّسة الجيران” التي تراقبها وتدير حياتها. ربّما يعود ذلك إلى فشلها في أن تكون “مؤسّسة” بحدّ ذاتها: مؤسّسةَ عائلة، ومؤسّسةَ أمّ، وفردًا مُنتجًا لمجتمعه، فتحاول الشخصيّة الرئيسيّة تقويم ما قدّمته عبْر التعليم هذه “المؤسّساتُ” ومندوبوها لابنَيْها، وتحاول جاهدةً أن تغرس في عقولهما مفاهيم مغايرة، وواقعيّة، لكلّ هذه الأدوار المتوقّعة منهما بوصفهما فردَيْن، وكذلك بوصفهما وحدة نواة واحدة.
على الرغم من غياب أسماء الشخصيّات في الرواية، ولا سيّما الشخصيّات الرئيسيّة فيها -الأمّ والابنة والابن- اختارت بيرنشطاين ذكْر بعض الشخصيّات المعروفة عالميًّا، منشِئةً تناصًّا مع شخصيّات نسائيّة ذات عمق رمزيّ يمثّلن طيفًا واسعًا من الاحتمالات النسويّة، المتناقضة في عدّة أحيان. من اللافت للانتباه أنّ جميع الأسماء هي لشخصيّات نسائيّة، على الرغم من التناقض بينها. على سبيل المثال، تذكر الكاتبةُ الشخصيّةَ الأمريكيّة آني أوكلي، التي وُلدت في الولايات المتّحدة في منتصف القرن التاسع عشر، والتي تحدّت الرجال في مسابقات إطلاق النار، وتغلّبت على أشهَرهم وفازت في المسابقات دائمًا. فشخصيّة أوكلي هي كذلك شخصيّة امرأة تصارع ما هو مألوف ومتّبَع في عصر افتقرت فيه المرأة الأمريكيّة إلى المساواة مع الرجل، وكان يُنظر إلى كلّ سلوك غير “أنثويّ” على أنّه تحدٍّ لطبيعة البشر، وخارجٌ عن حدود ما هو مقبول اجتماعيًّا. وذَكرت أيضًا الشاعرةَ والكاتبة الأمريكيّة سيلـﭭـيا ﭘـلاث، التي اشتُهِرت بجانر “الشعر الاعترافيّ” (confessional poetry) الذي تناول تابوهات اجتماعيّة وطَرَحَها بأدوات أدبيّة وشعريّة. فـﭙـلاث، كمثل الشخصيّة الرئيسيّة في الرواية، لـمّحت كثيرًا في كتاباتها إلى أمراضِها النفسيّة، وأفكارِها الانتحاريّة، واكتئابِ ما بعد الولادة، إلى أن وضعت حدًّا لحياتها بعدما أنجبت ابنها الثاني. طرْحُ اسم ﭘـلاث في الرواية ليس عفويًّا، ويدفع القارئَ إلى التساؤل بشأن مستقبل بطلة الرواية. فهي كذلك تعاني من اكتئاب مزمن، كما أنّها في العشرينيّات من عمرها، ولدَيْها ولدان. تلمّح الشخصيّة الرئيسيّة إلى غزلها مع فكرة الموت عندما تقول: “على الرغم منّي، انحشرتْ في رأسي صورة رأس سيلـﭭـيا پلاث وهي في فرن الغاز. رأيتها وهي تلفّ المناشف البيضاء، وتدفعها في الفتحة التي بين غرفة الأطفال والأرضيّة. لا أمتلك الشجاعة. أنا جبانة، هكذا فكّرت. لن أتمكّن من ضخّ حياتي منّي” (ص 85). هناك تناصّ إلى حدٍّ كبير بين شعر وأدب پلاث وسيرة حياتها من جهة، والشخصيّة الرئيسيّة في الرواية من جهة أخرى؛ ففضلًا عن عللهما المتشابهة، تطمح الشخصيّة الرئيسيّة أن تكون كاتبة، وتستجمع ما بقي لديها من طاقة ضئيلة كي تكتب كلمة، أو جملة، في روايتها التي قيد الكتابة. يدفعني التناصّ والتشابه الكبير بين سيرةِ حياة پلاث وأحداثِ الرواية، وسيرةِ حياة بيرنشطاين نفسها، إلى التساؤل حول فعل الكتابة، بحدّ ذاته، كأداة يمكنها أن تعطي المرأة الأمّ صوتًا، وتنقذها من شياطينها الداخليّة ومن انغماسها في روتين المهامّ اليوميّة الصغيرة والتافهة التي تنطلي عليها لكونها أمًّا وزوجةً. ليس من قبيل المصادفة أنّ الشيء الوحيد الذي ترغب الشخصيّة الرئيسيّة في الرواية أن تقوم به هو الكتابة، وحُلمها أن تكون كاتبةً. بل ثمّة ما هو أكثر من ذلك؛ فهي تحلم بأن تلتقي بالكاتبة التي درّبتها على الكتابة في رحلتها، وهي متأكّدة أنّها الوحيدة التي ستفهمها وستدرك ما تحاول أن تقوم به. باتت الكتابة لكلّ هؤلاء البطلات متنفَّسًا، وصوتَهنّ الصارخَ على الورق، ولا سيّما عندما لا يقوَيْنَ على الكلام المباشر.
هذا يأخذني إلى ترجمة هذه الرواية وتحدّي نقل صوت الراوية الجارف، المتقطّع والمتواصل في آن، والمشوّش والواضح في آن. فالكتابة الروائيّة العربيّة تتّسم بالبلاغة وكثرة الأوصاف والأصوات، وبالحِوارات البنيويّة الواضحة والتسلسل الزمنيّ الخطّيّ. على فعل الترجمة، برأيي، أن ينقل صوت الكاتب/ة والراوي/ة كما هو، مع أقلّ قدر ممكن من التفسيرات والتلقين والتلقيم. في هذه الرواية عشرات الإشارات إلى الثقافة الإسرائيليّة، والدين اليهوديّ، والأيديولوجيا الصهيونيّة التي قد لا تكون واضحة ومفهومة للقارئ العربيّ. اتّخذنا، أنا وطاقم تحرير وإنتاج هذا الكتاب، من خلال منهجيّة الترجمة الحِواريّة المتّبَعة في سلسلة “مكتوب”، قرارًا بألّا نضع ملاحظات وتفسيرات لهذه الإشارات، علمًا أنّه بإمكان القارئ البحث عنها وعن معانيها ورموزها في شبكة الإنترنت أو مصادر المعرفة الأخرى، لئلّا نقطع جرف القراءة الذي من المفروض أن يكون أداة من أدوات قراءة وعيش هذه الرواية تحديدًا. على سبيل المثال، عندما تقول البنت “أنا أكره مَلِكات ’إستير’ […] لن أتنكّر بزيّ ملكة إستير بحياتي” (ص 150)، بإمكان القارئ العربيّ أن يبحث عمّن تكون الملكة إستير، وأن يفهم لوحده أنّ البنت، عمليًّا، تكره أن تكون “المرأة الجميلة العفيفة” التي يختارها الملك لتكون زوجةً له بسبب جمالها، وتتحوّل فيما بعد إلى قائدة اليهود ومنقذتهم من وزير الملك الذي خطّط لإبادتهم، وبالتالي لن تكون البنت “بحياتها” منقذةً لليهود، أو قائدةً لهم. بالنظر إلى سيرة حياة بيرنشطاين ومواقفها اليساريّة، يمكننا أن نفترض أنّ اختياراتها الأدبيّة هذه لم تكن محض صدفة. ففي إشارة أخرى في الرواية، تؤكّد الشخصيّة الرئيسيّة لابنَيْها أنّه على الرغم من أنّ مدينة الملاهي هي اليوم في مدينة تل أبيب، فقد كانت -عندما زارتها في طفولتها- في يافا: “في الأصل كانت مدينة الملاهي في يافا […] يافا هي جزء من تل أبيب، ولكنّها كانت مدينة قائمة بحدّ ذاتها في الماضي. ذات مرّة” (ص 145).
“فقط لو يدرك الرجال المعنى العميق للأمومة، لأصبحوا شركاء كاملين في تربية أبنائهم. لدعموا النساء اللواتي أنجبن أبناءهم لهم؛ اللواتي احتضَنَّ جيناتهم في أرحامهنّ. لكانوا تكلّموا معهنّ، وأصغَوْا لهنّ، وحملوهنّ على أكتافهم” (ص 113). أختم مع هذا الاقتباس من الرواية الذي أعتبره، شخصيًّا، مانيفيست هذا العمل الأدبيّ، وأُهدي هذه الترجمة إلى جميع الأمّهات، الضعيفات منهنّ والقويّات، القائدات والـمُسيَّرات، المرهَقات نفسيًّا والـمُعافَيات. أنا متأكّدة أنّ جميعهنّ سيجدن أبعادًا من أنفسهنّ ونفسيّتهنّ في شخصيّات هذه الرواية، ويَحْدوني أمل أن تسهم قراءتها في أن نرأف بالنساء اللواتي مِن حولنا ويعانين من الفقر وفقدان الصحّة البدنيّة والنفسيّة، ومن الوَحدة وانعدام العاطفة، ومن محاربة شياطينهنّ الداخليّة والمجتمعيّة، علّنا نتخلّى عن إصدار الحكم عليهنّ وعلى ضعفهنّ الذي قد يبدو، أحيانًا، طوعيًّا.
حازت الرواية غدًا سنسافر إلى مدينة الملاهي على جائزة “سـﭙـير” للأدب العبريّ للعام 2019، وهي أوّل رواية من روايات الكاتبة إيلانا بيرنشطاين تُترجم إلى اللغة العربيّة. بودّي أن أشكر الطاقم الرائع الذي أسهَمَ في إنتاج هذا الكتاب على الحِوار المثري الذي رافق العمل، وأخصّ بالذكر محرّرة الترجمة كفاح عبد الحليم، والمدقّق اللغويّ حنّا نور الحاجّ، ومُراجِعَيِ الترجمة ﭘـروفسور يهودا شنهاﭪ – شهرباني وَد. يوني مِندل، وسكرتيرة التحرير حنان سعدي، والمصمّمة أمل شوفاني، ومصمّم لوحة الغلاف فراس شحادة. يَصدر هذا الكتاب ضمن “سلسلة مكتوب” في معهد ﭬـان لير، وهو الإصدار الأوّل من مجموعة “زفير” -مجموعة ترجمة الكتب الحائزة على جائزة “سـﭙـير” للأدب العبريّ-. أرجو أن تَكون ترجمة هذه الرواية إضافة إلى المعرفة باللغة العربيّة بشأن المجتمع الإسرائيليّ، وأن تُلقي ضوءًا آخَر على الصراعات التي تخضع لها النساء، كلّ النساء، في هذه البقعة من الأرض.



 قلم رصاص ومحّاية
قلم رصاص ومحّاية  ترشيحا
ترشيحا  معليا
معليا 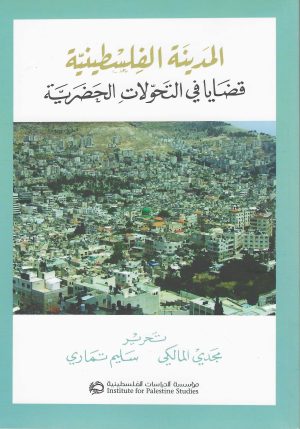 المدينة الفلسطينية: قضايا في التحولات الحضرية
المدينة الفلسطينية: قضايا في التحولات الحضرية